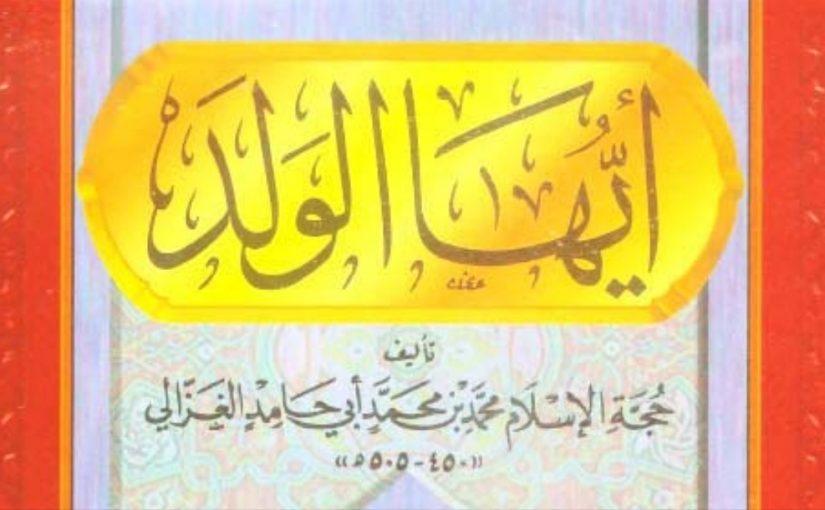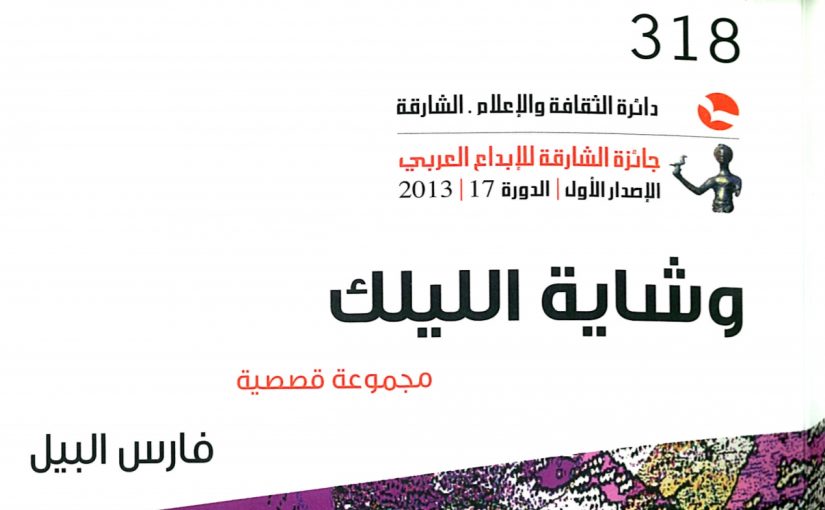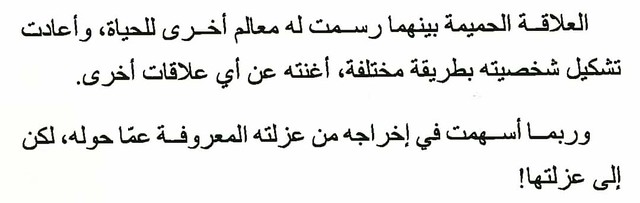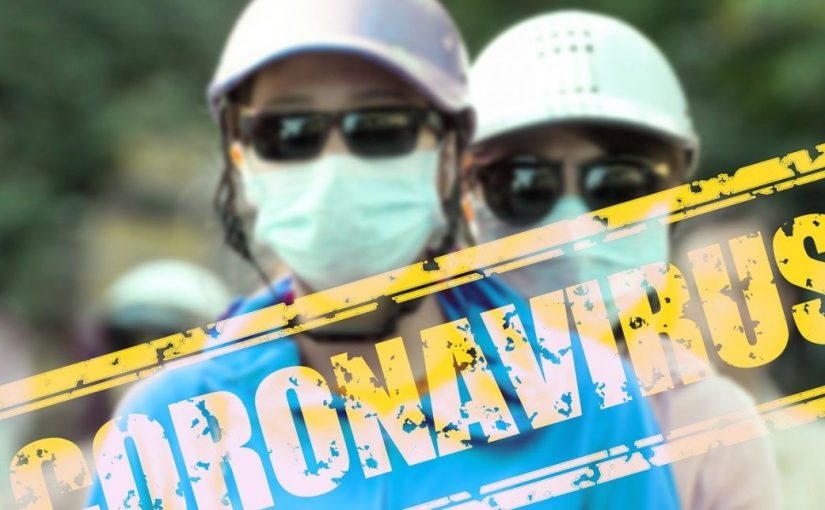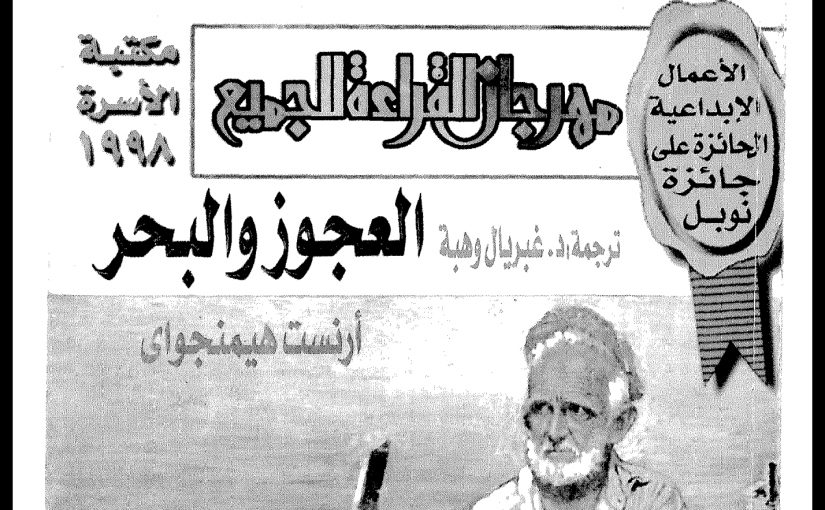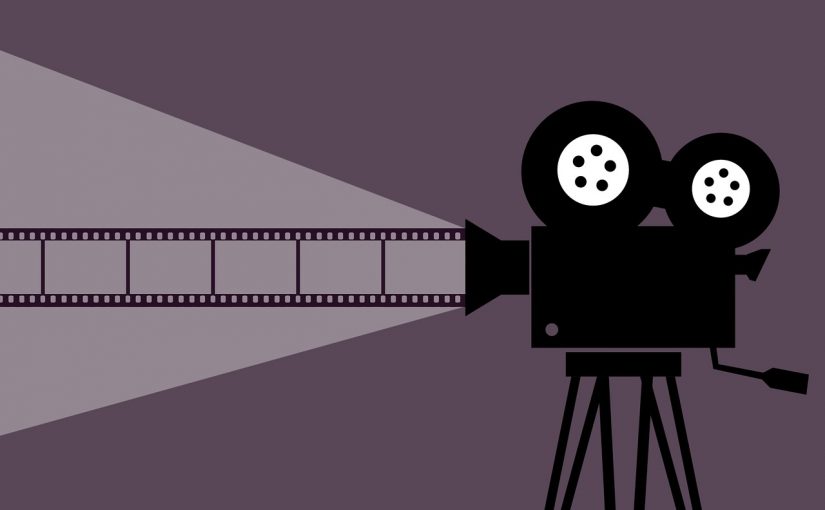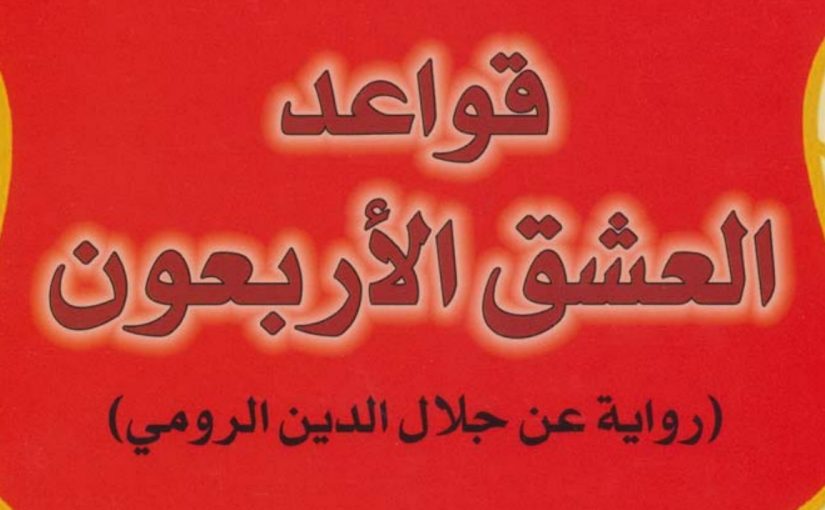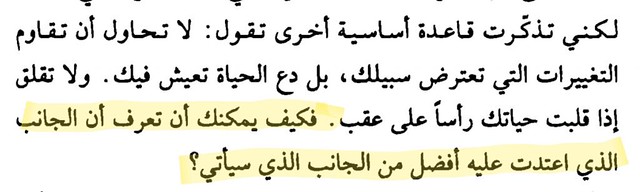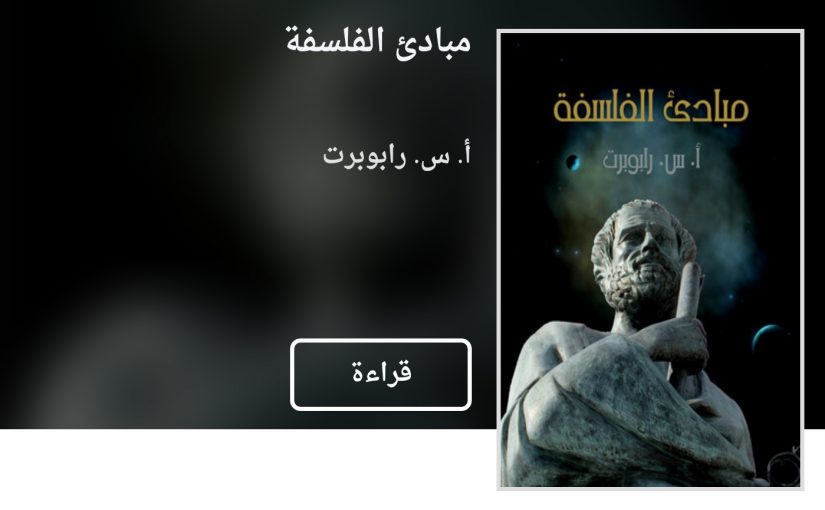من القرارات الجيدة التي عقدتها بداية هذه السنة، هي أن أكتب كل الأفكار والتأملات دون تأجيل، فلقد أدركت أني إن لم أكتبها في حينها، ولو في صيغتها الأولية، فسيصبح من الصعب علي إمساكها بعد ذلك أو تدوينها كما كانت مشرقة ناصعة حين الولادة.
ومن القرارات السيئة؛ أني قررت أن أكتب تلك الخواطر في جدار الفيسبوك، ذلك الجدار سيئ السمعة، من ينمي الرياء في القلب كما تنمو النبتة في فصلٍ ماطر، لذلك فقد قررت أن أكتب هذه الخواطر هنا في المدونة، بعيداً عن الزحمة، أن أكتبها طيلة الشهر حين ورودها في صفحة واحدة ثم أنشرها نهاية كل شهر، وبالتالي ستكون سلسلة شهرية لتدوين الخواطر الفكرية، كل صفحة بها خواطر وتأملات ما جاد به العقل طيلة أيام الشهر.
7- أحلامٌ مؤجلة
ولي أحلامٌ تنتظر حكم التنفيذ، لا هيَّ أعتقتني ولا أنا قادرٌ على التخلي، تتناوبُ عليَّ أطيافها، وتنعش القلب بالتذكير، فأجبر خاطرها بكلمتين؛ سيأتي يوم ولادتك المشهود، وسأعلن عن هذا بفرحة وسرور، سأخبرهم أن ربي كريم، لا يُضيع حلمَ حالمٍ منا، سيأتي يومٌ، سيأتي يوم.
6- التكلف عدو الاستمرارية
وقعتُ على مدونة أحدهم وتصفحت بعض ما كتبه صاحبها فيها، وجدت كلام من أعذب الكلام، وتدوينات رائعة الجمال، لكن صاحبها متوقف عن الكتابة منذ 2015، قد يكون السبب هو انشغاله بالحياة وطلب الرزق فيها، وقد يكون أمرٌ آخر، ثم عدت إلى مدونتي هذه فحدثت نفسي: وأنت يا عمر، متى هو يا ترى موعد هجرك للمدونة؟ حزنت، ثم فكرت وقلت في نفسي: حين تصبح الكتابة أمراً سهلاً وسريعاً، حينها يمكن الاستمرار لأنها لن تعيقني عن الحياة والإنجاز، لذلك فلا يجب أن أتكلف كثيراً أثناء الكتابة، ما أن تردني فكرة أو خاطرة أو فائدة إلا وأكتبها بشكل عفوي، لا يجب علي أبالغ في البناء اللغوي أو في المحتوى المعرفي، كي لا أمل ولا أترك …. إن التكلف عدو الاستمرارية، هوس الإتقان يمنعك من الاستمرار.
5- ثقافة القتل
في الأفلام السينمائية، المخرج هو الذي يتحكم بمشاعرك، فساعة يغدو القتل أمراً هيناً جداً، وساعة يصبح أمراً عظيماً وفعلاً شائناً إلى أبعد الحدود، تشاهد البطل وهو يقفز ويصارع الأعداء فيطرح ثلة عن يمينة، ويقضي على ثلة أخرى عن شماله دون أن يغمض له جفن ولا أن يتوقف أو يتردد أو يفكر، وأنت تمضي معه في رتم الأحداث، وكأن أولئك ليسوا سوى دمىً أو بشر آليين ليس فيهم أرواح ولا من خلفهم قصص وآمال وأسر وأطفال.
ثم في فيلم آخر، حين يريد المخرج أن يحرك مشاعرك ويكسب تعاطفك، تغدو الحركة أبطأ، والأحداث أكثر تفصيلاً، حتى إذا انطلقت تلك الرصاصة الغادرة وأصابت ذلك الشخص الذي يريدك المخرج أن تتعاطف معه، حينها ستتوقف الكاميرا طويلاً عنده، وليست كاميرا بلا كاميرات كل واحدة من زاوية، سيصور لك ألمه ومعاناته، سيأتي رفيقه وينزل دمعتين على خده، حينها سيغدو القتل في نظرك أمراً فادح السوء والوحشية.
لهذا السبب -وأسباب أخرى- لا أحب الأفلام التي توصف بأنها (أكشن)، وللأسف هذه الأفلام خطيرة على المجتمعات وعلى الإنسانية بأكملها، القتل لا يجب أن يصبح ثقافة سائدة وأمراً عادياً، يفترض بنا أن نعالج المشكلة في شاشاتنا أولاً، حتى نتمكن من معالجتها في واقعنا.
4- من يحبون الله
قرأت بعض كلام جلال الدين الرومي، وتأملت بعض أحوال الصوفية، ثم تأملت في المحب حين ينغمس في حب فتاة تأخذ قلبه، كيف يتغير حاله، يعيش معنا بجسده لكن لديه أحوال مختلفة، وقد يقدم على أمور لا يمكن أن نقدم عليها نحن، وقد يوصف بالجنون، بل أنهم وصفوا بذلك أشخاص (مجنون ليلى على سبيل المثال)، وهذا كله عندما يحب الإنسان إنساناً مثله، فكيف بمن يحب الخالق جل وعلى، حباً صادقاً لا ادعاءً، من الطبيعي أن تتغير أحواله، وقد لا نعي ما يمر به من أحوال، وقد لا نصدق أو ننكر عليه، والكثير من المحبين الحقيقيين لديهم أشياء غريبة وخوارق لكن لا يظهرونها للآخرين، فلن يفهم أحد، لن يفهم إلا من ذاق الحب الحقيقي، فهو أمر خارق للعادة، أن يحب الإنسان -بصدق- ربه.
نسأل الله أن يرزقنا حبه، وحب من أحبه، وحب كل عمل يقربنا إلى حبه.
3- وقت خروج الطيبين
وقت خروجهم هو الصباح الباكر، ألقاهم حين أركب قطار المدينة الذي يشقها نصفين، ويقطعها من الأول إلى الآخر، بعد الفجر، ووقت الشروق تسمع هديره يشق جدار الصمت، أركب فيه لأجد الرجال الحقيقيين، من يبكرون إلى أعمالهم ويعيلون أسرهم، وعادة ما يكونوا العمال الكادحين، والموظفين المغمورين.
حين أركب القطار باكراً، أجد صنف خاص من البشر، الصنف الذي تطمئن إلى الحياة بوجودهم فيه، فعلى الوجيه ترتسم ملامح السماحة، البعض منهم يمسك مسبحته ولا يفتأ يفرك حباتها بأصبعه، أخرون يحملقون في شاشة الهاتف وينهلون من معين الحقيقة (القرآن)، وحتى أولئك الذين لا يفعلون شيئا، يكفيهم فخرا أنهم من أصحاب البكور، ينامون مع اختفاء الشمس، ويصحون وقت ظهورها.
أحب أن أركب القطار باكراً، فهذا يعطيني طاقة كبيرة، ويبعث على نفسي السكينة، ويذكرني بأن أستمر في العمل، في السعي، في خوض هذه التجربة الفريدة؛ تجربة الحياة.
2- مجلس غِيبة داخل المسجد
قضيت مساء الأمس مع صديقي، لقيته في المغرب وجلسنا نصف ساعة نتحدث بينما كان المطر ينهمر، خرجنا فاشتهينا المشي على الأرض المبتلة بعدما توقف، وبعد مسافة ليست قصيرة، دخلنا مسجداً آخر لصلاة العشاء، وبعد الصلاة رأى صديقي ورقة مكتوبٌ عليها “لا تنسى نية الاعتكاف في المسجد” فاقترح علي أن نعتكف نصف ساعة في المسجد، نظرت إليه وابتسمت وقلت “ماذا نفعل في هذه النصف ساعة؟ نغتاب كما فعلنا بعد المغرب!”
لقد حدثني في المسجد بعد المغرب عن زوجته، كان يشتكي منها ومن أفعالها، في تلك الأثناء حين كنت أستمع له، لم أكن أدرك أنني كنت أستمع للغيبة، أنني كنت أرتكب إثماً، بل اعتقدت أني كنت أعمل صالحاً، بأني أفتح له قلبي ليبث فيه ما يريد، لكن ما كنت أجهله أن صورة سيئة عن زوجته قد انطبعت في عقلي اللاواعي بسبب ما سمعت منه.
هذه هي خطورة الغيبة بشكل عام، خطورتها في أنها تشكل الصور السلبية للأشخاص في العقل اللاواعي، فيتسرب الكره وبقية المشاعر السلبية إلى القلب ولو بالشيء اليسير دون أن تشعر، أو تقل مشاعر الحب والرأفة والرحمة لذلك الإنسان الذي تمت غيبته أياً كان، والمفروض أن يمتلئ قلب المؤمن بهذه المشاعر لا بتلك، فهي التي يرتقي بها ومعها في مدارج الكمال.
كأن الامتناع عن الغيبة هذا هو هدفه، يريد ربنا أن ترتقي أرواحنا، أن نتخلق -حقيقتاً- بصفاته، ولن يكون ذلك الا بصدق مشاعرنا وأحاسيسنا، والغيبة تقتل ذلك فينا.
إن الغيبة منتشرة جداً فيما حولنا، نتورط فيها كثيراً سواءً قائلين أو سماعين، ويجب على المؤمن أن يشدد الحراسة على لسانه وسمعه، وهذا هو تطبيق عملي لمفهوم “التقوى”.
1- إجري على رزقك إجري
اليوم دخلت المتنزه الكبير بعد أن أوصلت ابنتي إلى المدرسة، كنت ألبس المعطف وأضع الشال على رقبتي لتحميني من برد الشتاء، وحين دخلت وانفتحت روحي أمام المشهد الفاتن، بدأت بالركض، ركضت ولست أرتدي ملابس الجري أو الملابس الرياضية، وبدأت أردد مع نفسي “إجري … إجري على رزقك إجري“!
مع بداية هذا السنة، صرت أكثر تهاوناً في موضوع العمل الذي يدر المال، ذلك المصدر الأهم للدخل والذي أستعين به على مصاريف العيال، تولدت عندي قناعة -رغم معرفتي بذلك- بأن الأسباب هذه التي نقوم بها ليس لها علاقة بالرزق، لأن الرزاق هو الله، وكم من مرة سعيت وسعيت ثم خرجت صفر اليدين، وأحياناً يأتيني رزقي دون حيلة مني، قررت أن أمضي في عملي لكن على هون، وسأتوجه إلى ربي وأخلص له في العبادة.
في الحقيقية؛ هنا يقع منزلق شيطاني، فالرزاق هو الله لاشك في ذلك، لكن الأخذ بالأسباب هو طاعة لله كذلك، وطريقة الأخذ بالأسباب تختلف من شخص لأخر بحسب طموحه، وأنا من الناس الطامحين في ما أعتقد، فلدي أحلام وأهداف وأفكار كثيرة، والله هو من يحقق لنا آمالنا وهو من يوصلنا إلى أحلامنا لا شك، لكن الله يريد منّا أن نجتهد في العمل والطلب، كلٌ بقدر أحلامه.
أنا لا أقول أني تركت الأخذ بالأسباب، لكن همتي في العمل ضعفت، وتكاسلي قد زاد، في حين أن أملي لازال كما هو بأني سأصل يوماً لتلك الأحلام الكبيرة، أعني: الله سيوصلني إليها.
بالطبع سيوصلني الله إليها ولست أنا من يفعل ذلك، بل أني لا أمتلك زمام أهم عضو في جسمي والذي يمدني بشرايين الحياة، لكن بجانب هذا كله، يجب أن أتذكر أن الله قد وضع قوانين ونظام دقيق، نظام قائم على السببية، ويجب علي أن أحترم هذا النظام وأن أمشي في ركبه، طاعة له وليس للأسباب.
أهم شيء هو أن لا يطغى العمل على الخطوط الحمراء التي أضعها لنفسي لحراسة الإيمان، أن لا يسرق العمل من وقت ذكر الله، لأنه كما نعلم وكما قال الله في كتابه (ولذكر الله أكبر)، وذكر الله ليس فقط (سبحانه الله والحمد لله و…الخ) وإنما الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله باللسان وبقية الأشياء المعروفة. إذاً يجب علي الاجتهاد في كلا الأمرين، في ذكر الله (الخطة الإيمانية) وفي العمل والأخذ بالأسباب (الخطة المعاشية)، والإيمان سيحمي القلب من التعلق بالأسباب أو النتائج.
المهم أني منذ اليوم -ان شاء الله- سأعود للجري، لن أكتفي بالمشي فقط، سأجري في طلب الرزق وفي إنجاز الأعمال وفي تحقيق التميز، سأخفف ساعات النوم وأستغل كل الوقت وأترك الملهيات ما استطعت إلى ذلك سبيلا (وأهمها الفيسبوك)، وهذا كله بجانب الجدية في ذكر الله، سأستمر في الجري، بجوارحي وقلبي، فنحن في دار العمل، في دار الجري.