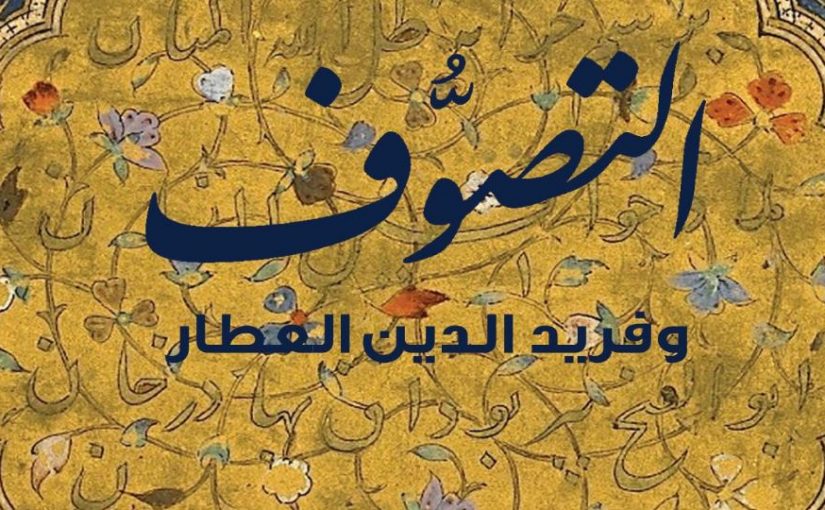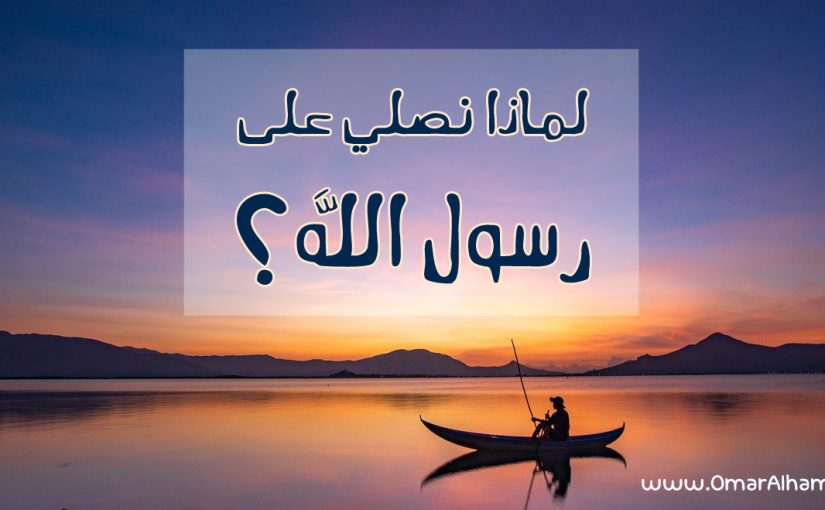مراجعة لكتاب: التصوف وفريد الدين العطار، لعبدالوهات عزام (رابط التحميل)
والحلاج -في رأي العطار- ملوم؛ لأنه لم يلتزم صورة الشريعة؛ هو عند العطار بطل الصوفية، ولكنه سماه لص الطريق؛ لأنه باح بالسر وهو قد خالف الشرع، وبهذا استحق العقاب.
اقتباس من ذات الكتاب
ولازلت أتتبع كتابات أولئك الصوفيين الأوائل، علي أكتشف ذلك السر الدفين، الذي وجدوه ولم يتمكنوا من البوح به، فقد قال الغزالي قبلها ناصحاً تلميذه: اعمل واجتهد حتى تصل، لأن تلك الأمور ذوقية، تلك الأمور لا نقدر على الحديث عنها، يجب عليك أن تجربها بنفسك.
وقالها “جلالها الدين الرومي” قال أن هنالك سر لا يمكن البوح به، سر يعرفه العارفون، وما يكتبوه لنا هو بعض طراطيش الكلام، وفيه بعض التلميح، ومن تلك التلميحات نتلمس بصيص النور علنا نتعرف على بعض ملامح ذلك السر العظيم، بالطبع هو عظيم، لأنه يرتبط بالعظيم، بالملك جل جلاله.
انتقلتُ من الغزالي إلى جلال الدين الرومي ثم تاقت نفسي لقراءة كتاب “منطق الطير” والذي هو عمل أدبي صوفي كتب أصلاً بالفارسية، أما كاتبه فهو “فريد الدين العطار” ثم وجدت كتاب يتحدث عنه وعن كتابه ذاك فقررت أن أقرأه أولاً حتى أدخل على حضرة العطار من باب الوقار، فأعرف أولاً لمن أقرأ، أما هذا الكتاب فهو (التصوف وفريد الدين العطار) للمؤلف: عبدالوهاب عزام المتوفي سنة 1959، وهو مفكر وكاتب وشاعر ترجم الكثير من الأعمال الفارسية إلى اللغة العربية باحترافية عالية، ويكفيه فخراً أنه من نقل إلينا أعمال الشاعر الكبير: محمد إقبال.
أقسام الكتاب
ينقسم إلى أربعة أقسام:
- التصوف الإسلامي: نشوؤه وتطوره
- التصوف والأدب
- فريد الدين العطار
- تصوف العطار
في الفصل الأول يذكر المؤلف (أصل التصوف) ثم يتحدث عن تطوره في ثنايا الحضارة الإسلامية، وقد ذكر كلاماً جميلاً مرتباً وقسم التصوف إلى مراحل وأطوار، وذكر في ثنايا ذلك بعض الشخصيات التي ظهرت في القرن الهجري الثاني (مثل الحسن البصري والفضيل بن عياض، وسفيان الثوري ومالك بن دينار وغيرهم)، على أنهم من أوائل الصوفية دون أن يكون هذا المصطلح معروفاً في ذاك الزمان، وقد وصفهم الكاتب بأنهم (غلب علي جماعة من هؤلاء الحزن والصمت).
ثم أتى جيل بعدهم، وصفهم الكتاب بأنهم (أعظم زهداً، وأقسى على أنفسهم، وأشد تذليلاً لها)، وقد شاعت تسمية (الصوفية) في أواخر القرن الثاني، ومن أمثلة أولئك (ابراهيم بن أدهم البلخي، وبشر الحافي المتوفي سنة 224هـ) وأيضاً (معروف الكرخي)، وممن ذكرهم في الكتاب (السري السقطي) وهو ما يذكر عنه شدة الورع والانغماس في العبادة والتبتل (انقر هنا لقراءة بعض أقواله وآثاره).
وقد تميز أولئك القوم بالتسليم والتوكل على الله في كل الأمور، وخوف من الله دائم، وسوء ظن بأنفسهم وتحقير لأعمالهم مهام عظمت.
ثم أتى جيل آخر من العباد والزهاد، كان ذلك في القرن الثالث الهجري، وغلب عليهم المعرفة والتأمل والحب الإلهي والفناء، وممن عاشوا في هذا العصر: ذو النون المصري – يحي بن معاذ الرازي – أبو يزيد البسطامي – سهل بن عبدالله التستري – والجنيد البغدادي – أبو عبدالله المحاسبي – الحلاج، ثم أخذ المؤلف بتعريف أربعة من أولئك لتباين طريقتهم.
والجدير بالذكر أن البسطامي من أوائل الصوفيين الذين قالوا كلاماً أنكره عليهم الناس، ولا ندري أصحيح ما ينسب إليه أم غير صحيح، حيث تنسب إليه المقولة: “ما في الجبة إلا الله”، وهي العبارة التي فد تفسر على أنها تعبير عن الفناء أو وحدة الوجود، ويدافع عنه آخرون تارة بأن كثيراً مما نسب إليه ليس حقاً، وتارة بأن الصوفي في بعض الأحيان يغلب على أمره ويدخل في حال يغيب فيها وعيه (حالة السكر) من شدة حبه لله وفناءه فيه.
أما الجنيد البغدادي، فقد كان عالماً عارفاً، كان فقهياً يلبس لباس العلماء، قال عنه المؤلف (كان يمثل أهل الصحو كما يمثل البسطامي أهل السُّكر)
أما الحلاج فهو صوفي عجيب الأطوار، وقد روي عنه كلام انكره علماء بغداد، منه قوله (أنا الحق) فأفتوا بقتله، فصلب، وقد ذكره الدكتور علي جمعة في مقطع حديث وأوضح الإشكال في دقائق قليلة (انقر هنا للمشاهدة)
وهكذا ظهر أولياء الله ومحبيه في كل زمان ومكان، فكان لؤلئك أخبار وأحوال، وانتشرت طرائقهم وتعددت أورادهم.
وقد ظهرت فئة منهم حقروا المظاهر كلها، وانتهى بهم إلى التقليل من شأن التكاليف الدينية الظاهرية، وانفتح بهذا باب لضعاف النفوس فخرجوا من التكاليف وأوهموا أنفسهم أنهم بلغوا المقصود من هذه التكاليف، ووجد بعض من لا يبالون بالتصوف ولا بالدين رخصة إلى ما يريديون.
وهؤلاء ليسوا صوفيين وإنما مدعين، وقد أنكر عليهم هذا الجنيد والقشيري وغيرهم من الصوفيين الحقيقيين، فقال الجنيد (هذا قول قوم تكلموا بإسقاط الأعمال، وهو عندي عظيمة، والذي يسرق ويزني أحسن حالاً من الذي يقول هذا، فإن العارفين بالله تعالى أخذوا الأعمال عن الله تعالى وإليه رجعوا فيها، ولو بقيت ألف عام لم أنقص من أعمال البر ذرة إلا أن يحال بي دونها).
التصوف والأدب
ثم تحدث المؤلف عن (التصوف والأدب) في فصل خاص، ذكر فيه بعض أدباء وشعراء الصوفية وبعض أشعارهم، وألمح إلى أن للشاعر والأديب لغته التي قد يستعين فيها بأمور من البلاغة، ومن الشعراء الذين غلب التصوف على أشعارهم ممن ذكرهم المؤلف: ابن الفارض – ابن عربي – غبدالغني النابلسي، وأورد المؤلف نبذة من كتاب (التوهم) للمحاسبي المتوفي سنة 243 هـ، وهو كتاب يحفزك على التخيل أو (التوهم) فتتوهم أنك في يوم القيامة ثم يسهب في التفاصيل والتخيلات.
وذكر المؤلف أيضاً اقتباسات من كتاب (المواقف) للنفري، وهو كتاب يحكي المؤلف فيه -بصورة تخيلية- بعض المواقف بين يدي ربه، وألواناً من الحوار بينه وبين ربه عز وجل، وفي صفحة الكتاب في Goodreads بعض المراجعات والاقتباسات منه.
ثم تحدث المؤلف عن الشعر الصوفي وأبرز رجاله، وقال:
وأما الأدب الفارسي، ويتبعه الأدب التركي والأدب الأردي فقد ترجم فكر الصوفية ووجدانهم بالشعر لا بالنثر.
وبلغ شعراء الفرس في هذه السبيل غاية لم يدركها شعراء أمة أخرى، فأخرجوا المعاني الظاهرة والخفية والدقيقة في صور شتى معجبة مطربة وقد فتح عليهم في هذا فتحًا عظيمًا فكان شعرهم فيضًا تضيق به الأبيات والقوافي والصحف والكتب حتى ليمسك القارئ أحيانًا حائرًا كيف تجلت لهم هذه المعاني، وكيف استطاعوا أن يشققوا المعنى الواحد إلى معانٍ شتى، ثم يخرجوا كل واحد منها في صور كثيرة عجيبة كأنها أزهار المرج ونباته تزدحم في العين ألوانها وأشكالها وماؤها واحد وترابها واحد.
كان أبو سعيد بن أبي الخير الخراساني من رجال القرنين الرابع والخامس (٣٥٧–٤٤٠ﻫ) فارط شعراء الصوفية في الأدب الفارسي فنظم رباعيات كثيرة هي أحسن ما في الشعر الصوفي من رباعيات فيما أعلم، وجاء بعده عبد الله الأنصاري المتوفى سنة ٤٨١ﻫ وله ديوان في الشعر الصوفي، ثم جاء الشاعر الكبير مجد الدين سنائي الغزنوي المتوفى سنة ٥٤٥ فنظم حديقة الحقائق ومنظومات أخر، وتلاه فريد الدين العطار فأكثر وفاض ونظم نحو أربعين منظومة، ثم جاء مولانا جلال الدين الرومي شيخ شعراء الصوفية كلهم فاستولى على الأمد، ونظم الديوان وهو شعر صوفي رقيق بليغ، والمثنوي وهو شعر وفلسفة وأخلاق وتفسير للقرآن والشريعة بأسلوب صوفي، وقد سماه المجبون به القرآن في اللغة الفارسية، وقالوا عن صاحبه: لم يكن نبيًّا، ولكن أوتي كتابًا.
ثم جاء عبد الرحمن الجامي العلم الشاعر المتوفى ٨٩٨ﻫ وهو يعد آخر شعراء الصوفية العظام.
وإلى جانب هؤلاء شعراء كثيرون لهم في التصوف شعر جيد كابن يمين، والعراق صاحب اللمعات، والشيخ محمود الشبستري صاحب المنظومة كلشن راز (حديقة السر) وقسم الأنوار والمغربي، ولا ننسى الشاعر العظيم الذي فاق الشعراء طرًّا بجمال شعره ودقته وإن لم يبلغ في الشعر الصوفي الصريح وفي الفلسفة مبلغ كبار الشعراء؛ وهو حافظ الشيرازي.
ولا يخلو شاعر فارسي من نزعة صوفية تظهر في شعره؛ لشدة ما سيطر شعراء الصوفية على الشعر الفارسي منذ نبغ كبار الشعراء الصوفية إلى يومنا هذا.
وختم المؤلف هذا الفصل بنبذة عن الشعر التركي، والذي سار وتأثر بالشعر الفارسي، ثم ذكر البلاد التركية الشرقية (تركستان) والتي هي الآن (كازاخستان) وهي التي نبغ فيها صوفي عظيم في القرن السادس الهجري، والتي -كما قال- لا تزال طريقته شائعة في تلك البلاد وبلاد أخرى، هو (أحمد اليسوي) وقد نظم باللغة التركية الشرقية (الشاغاتية) ديوان أسماه (ديوان الحكمة).
تمت ترجمة كتاب (ديوان الحكمة) إلى العربية مؤخراً على يد أحد المترجمين التركيين
الفصل الثالث: فريد الدين العطار
في هذا الفصل تعريف للشاعر الصوفي “فريد الدين العطار” المولود سنة 513 هـ، وقد عاش ومات في نيسابور.
وحين تتبعت مكان وتاريخ نيسابور عبر فضاء الانترنت، وجدت أنها حالياً أحد مدن دولة إيران (تسمى حالياً نيشابور)، وقد دخلها المسلمون في السننة 31 هـ، وهنا فيديو مختصر يحكي تاريخها، وهذا فيديو آخر فيه معلومات مختصرة عنها، ولمن أراد التعمق فليقرأ صفحتها في الموسوعة الحرة.
ونيسابور هي أحدى مدن خراسان، وخراسان هذه أحد المعالم الإسلامية البارزة، هي منطقة وساعة شملت عدة مدن ونبغ فيها علماء ومتصوفون وأشخاص تركوا أثراً بعدهم، جزء منها حالياً يقع في إيران، وأجزاء منها في الدول المجاورة، وقد ذكر المؤلف عنها الفقرة التالية:
ولا يتسع المجال هنا لبيان مكانة خراسان في العالم؛ شعوبه، وتجارته، وثقافته؛ إذ كانت موصل إيران وآسيا الغربية وأوربا وأفريقية وآسيا الشرقية والشمالية؛ ولكني أكتفي بالإشارة إلى صلة هذا الإقليم بالتصوف، كثير من الصوفية الأولين عاشوا هم أو آباؤهم في هذه البقعة من الأرض؛ فإبراهيم بن أدهم، وشقيق البلخي، وبشر الحافي، وفضيل بن عياض، وأبو يزيد البسطامي، وحاتم بن علوان الأصم، وأبو حفص الحداد، وأبو عثمان الحيري، والقشيري، والغزالي، وأبو سعيد بن أبي الخير، والعطار، وجلال الدين الرومي؛ كل هؤلاء من هذا الإقليم أصلًا أو منشأ.
الفصل الثالث والرابع فقد تناول فريد الدين العطار بالتعريف والبحث وكذلك تصوفه وآثار تصوفه فيما كتب ووصل إلينا من أشعاره، والعطار كان يكتب الشعر في اللغة الفارسية لكنه حين نقل إلينا نقل نثراً في الغالب، وأشهر عمل له هو (منطق الطير) وقد قدم المؤلف لهذا العمل تعريفاً واختصاراً لمجمل ما قيل في فصوله وأجزاءه.
تناول المؤلف في احد الفصول تعريفاً لفريد الدين العطار ومكان ولادته وبحثاً وتقصياً لتاريخ وفاته، وهو التاريخ الذي لا تتفق عليه المصادر، والعطار لا يُعرف عنه الكثير، وأكثر معرفتنا به هي من خلال ما كتب ووصف به نفسه، لكن المعلوم أن أبوه كان عطاراً، وقد ورث هذه المهنة منه، ولذلك يلقب بالعطار، أما وفاقته فقد كان في المدينة ذاتها (نيشابور) ولديه ضريح هناك يمكن زيارته، أما تاريخ وفاته فمختلف فيه لكن أكثر الروايات تذكر أنه توفي في 627 هـ، ويذكر البعض أنه قتل حين هجم التتار على المدينة في ذات السنة والذي تسبب إلى مقتل معظم سكان المدينة بحسب المصادر.
كان العطار عطاراً يعطي الدواء لمن يحتاجه في دكانه، وقد بدأ التأليف وهو لايزال عطاراً يعمل في الدكان، وكان صوفياً حين كان عاملاً في دنياه، لكن انقطع بعد ذلك وترك حانوته وسافر إلى بلدان وصاحب مشايخ وأولياء.
وسواء أقُتل العطار أم مات فقد فارق عيشة حزينة قلقة وهو يقول: «عاش ولم يرَ وجه الحياة.»
كان صوفيًّا ناسكًا قطع من الدنيا علائقه، وعاش زمنًا طويلًا معتزلًا متعبِّدًا متأملًا ناظمًا عقائده وآراءه وتجاربه، والظاهر أن هجرة العطار، وانقطاعه للتصوف أدى به إلى الفاقة، وكان أعفَّ وأزهدَ من أن يسأل الناس المعونة أو يقبل من أحدهم هبة
للعطار منزلة كبيرة بين الشعراء الصوفيين، ويمكن أن يكون هو وجلال الدين الرومي أشهر شاعران صوفيان كتبا بالفارسية، وقد ذكر المؤلف بعض قول العطار عن نفسه وعن شعره (اعتداده بنفسه) ثم ذكر بعض أقوال الآخرين عنه.
يقال أن العطار بارك جلال الدين الرومي في صغره وأعطاه كتابه حينما مر بنيسابور صبياً في صحبة أبيه وهو في طريقه إلى العراق، ويقال أن الرومي من أتباع العطار يدور حول كوكبه.
وقصارى القول: إن الصوفية والأدباء يكادون يجمعون على أن العطار وجلال الدين الرومي أكبر الصوفية من شعراء الفرس، وإن يكن جلال الدين أبعد ذكرًا وأوضح طريقة.
وأحسن ما قيل في القياس بينهما ما رواه مؤلف «هفت أقليم» أن صوفيًّا كبيرًا سُئل عنهما فقال: إن الرومي بلغ قمة الكمال — كالنسر — في طرفة عين، والثاني بلغ القمة نفسها، ولكن كالنملة بعد سير طويل ودأب لا يفتر.
ثم ختم المؤلف هذا الفصل بذكر مؤلفات فريد الدين العطار، والعطار غزير الكتابة، كتب الكثير وألف الكثير من الشعر الفارسي الصوفي، وقد عدد مؤلف هذا الكتاب 22 كتاباً وذكر أن هنالك كتب أخرى تنسب إليه، لكنه اكتفي بما هو متحقق منه.
تصوف العطار
تصوف العطار واضح لا يمتلئ بالرمزيات كما -مثلاً- في أشعار حافظ الشيرازي، يقول حيناً في أشعاره أنه بلغ وأبلغ كلما في الخاطر، وأحياناً يقول بأن كيف له أن يظهر ما لا يمكن إظاهره، وهو الشائع بين الصوفية في عدم الإفصاح عن كل الأسرار والأمور الذوقية، فكيف للكلام أن يصف ما لا يمكن بلوغه إلا بالذوق؟
العطار يعظم رسول الله والشريعة، ويعلن أن كل أدلته مستمدة من القرآن، وقد عقد فصولاً كثيرة يبين فيها اتفاق الشريعة والحقيقة.
يعترف العطار في بعض أقواله أن العقل باحث ذكي مدقق أحياناً، وأنه يدرك نظام العالم، وأنه هدى إلى الرشد، ولكن لا ينبغي أن يقف الإنسان في مستواه، وعليه أن يسمو إلى مستوى العشق.
يقول العطار: إذا اجتمع العقل والدين والعشق أدرك الذوق كل الأسرار التي يبتغيها الطالب
يذكر المؤلف بعد ذلك رأي العطار في الفلسفة، ثم تصور العطار لله والعالم والإنسان، ويذكر فيها موضوع “وحدة الوجود” والفرق بين تصوفر العطار وبقية الصوفية لهذا المفهوم وتصور الفلاسفة اليونان
العالم عند العطار هو تجلي الله، أو هو كالظل من الشمس، والصورة في المرآة، وقد ضرب في «منطق الطير» مثلًا، ملكًا لم يجرؤ أحد على رؤيته أو لقائه، فأراد أن يمكِّن رعيته من رؤيته فصعد فوق قصره وأمر أن توضع مرآة على الأرض تجلى فيها وجهه فرأته الرعية.
ثم يتحدث المؤلف عن (الله والإنسان) ويذكر كلاماً ممزوجاً بأقوال العطار وغيره من الصوفيين، ويحاول أن يفسر مغالاة بعضهم وقولهم (أنا لله) وهي العبارة التي ذكرت أيضاً في أحد كتب العطار، يتحدث العطار عن الروح وعن النفس وكيف نزلت وكيف تتصل بالعالم. ويعقد المؤلف فصلاً آخر بعنوان (القضاء والقدر) وماهي فلسفته في هذا الخصوص، ولعلنا نكتفي بهذا الاقتباس:
يتحدث المؤلف بعد ذلك عن الطريقة وعن الحال والمقام (في فصل سماه: الطريقة) وذكر قولاً مفيداً للقشيري حول الفرق بين الحال والمقام، ثم يورد بعض أقوال العطار وغيرهم فيما يخص “الهدف” الذي لا يمكن بلوغه، والطريق الذي لا نهاية له:
غاية الطريق التي يسير إليها الصوفي تكاد تكون غاية لا تدرك. يقول: «إنك تسير في طريقه مائة قرن ثم تجد نفسك عند الخطوة الأولى»، وهذا يذكرنا بقول الشيخ سعدي الشيرازي في مقدمة الكلستان: “يا من هو فوق الخيال والقياس والوهم، وفوق كل ما قالوا وسمعنا وقرأنا! انتهى المجلس وبلغ العمر منتهاه ولا نزال كما كنا في أول وصفك”
ويقول العطار: “كيف أمضى قدمًا وكأن مائة وادٍ تلوح في كل نفس؟ لا علامة في هذه الطريق، وإنما علامته الواحدة أن لا علامة فيه”. وفي (مختار نامه) يعقد الشاعر فصلًا بهذا العنوان: «في اليأس والاعتراف بالعجز». وسواء أكانت الغاية مما يدرك أو ما لا يدرك فيجب على السالك أن يفكر فيها ويعمل لها دأبًا.
ملخص كتاب منطق الطير
ويختم المؤلف كتابه بوصف وتخليص لما جاء في كتاب “منطق الطير” فقد ذكر باختصار تلك الوديان السبعة التي تقطعها الطيور في سيرها إلى الملك، ثم يورد بعض أقوال الطوير وكلامهم مما ذكره العطار في ملحمته كما يسميها البعض
بعد أن يتزود السالك بالخلال التي بينها الهدهد، في القسم الأول من منطق الطير، يبدأ رحلته فيقطع الأودية السبعة التي وصفها في القسم الثاني من الكتاب الذي سماه مقامات الطيور، وهي أودية: الطلب، والعشق، والمعرفة، والاستغناء، والتوحيد، والحيرة، والفقر والفناء.
وهي أودية متشابهة بما ملأتها حماسة العطار وغلوه بالهول والحيرة؛ ولكن لكل وادٍ، بجانب الأوصاف العامة، خصائص تميزه من غيره.
وهكذا ينتهي هذا الكتاب الماتع، الذي طاف بأودية التصوف وجال في عقول الأولياء، ثم ختم بالغوص عميقاً في عقل أحد روادهم، إنه العطار، فلله دره، ولله درهم، أولئك الذين تباركت الأرض بهم، فلم يغادروها حتى نثروا فيها بعض أزهارهم، ولازلنا نشتم روائحها الزكية حتى اليوم، ونتعطر برحيق كلماتهم.
انتهيت من قراءة الكتاب في الثالث عشر من شهر أبريل 2020 (عام الكورونا)، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم.